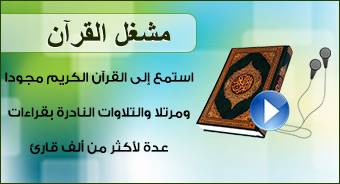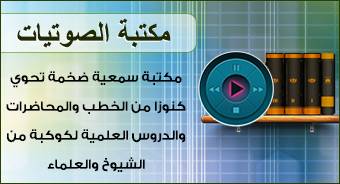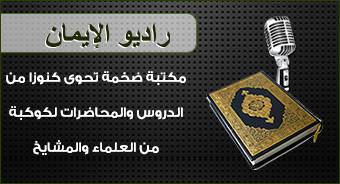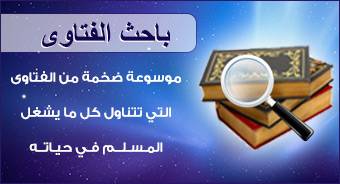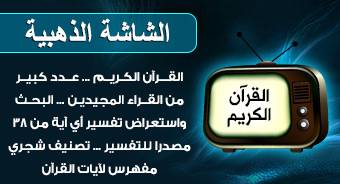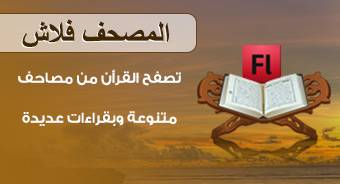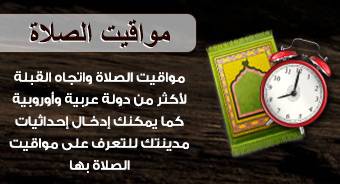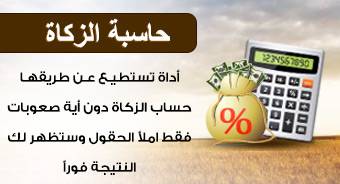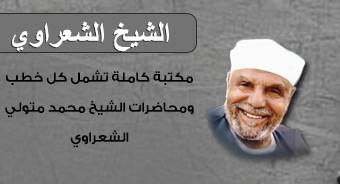|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[المفردات ص 94، والحدود الأنيقة ص 71، والتوقيف ص 245].
[المطلع ص 280].
قال ابن فارس: (والجعل، والجعالة، والجعيلة): ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. اصطلاحا: أن يجعل- جائز التصرف- شيئا- متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما- كرد عبده في محل كذا أو بناء حائط كذا. وقال ابن عرفة: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلّا بتمامه. أو: التزام عوض معلوم على عمل معين. تفترق الإجارة عن الجعالة: في أن الجعالة: إجارة على منفعة مظنون حصولها ولا ينتفع الجاعل بجزء من عمل العامل وأقام بتمام العمل، وهي غير لازمة في الجملة. [معجم المقاييس (جعل) ص 216، والمفردات ص 94، والمغني لابن باطيش 1/ 406، وفتح الباري/ مقدمة ص 103، والمطلع ص 281، وفتح الوهاب 1/ 267، والروض المربع ص 330، والموسوعة الفقهية 1/ 253، 3/ 326، 24/ 273].
[معجم المقاييس (جعد) ص 217، والقاموس المحيط (جعد) ص 348، والمصباح المنير (جعد) ص 39، ونيل الأوطار 6/ 274].
واقتصر عليه في (البارع)، ونقله جماعة عن الأصمعي، وهو مضبوط كذلك في (المحكم)، وعن ابن المديني: العراقيون يثقلون الجعرانة، والحديبية، والحجازيون يخففونهما، فأخذ به المحدثون على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب، وليس للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة إلا ما حكاه في (المحكم) تقليدا له في الحديبية، وقال الشافعي: المحدثون يخطئون في تشديدها، وكذلك قال الخطابي. [المصباح المنير (جعر) ص 40، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 58، 59].
[المصباح المنير (جعر) ص 40، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 128].
وبالضم-: ما يرمى به القدر، أو الوادي إلى جوانبه، ومنه: جفا السرج عن ظهر الدابة: تباعد. [نيل الأوطار 2/ 244، والتوقيف ص 247].
- قال ابن الأعرابي: (الجفر): الحمل الصغير بعدها يفطم ابن ستة أشهر، آخر كلامه. وسمّى الجفر بذلك، لأنه جفر جنباه: أي عظما. [تهذيب الأسماء واللغات 3/ 52، والمغني لابن باطيش 1/ 271، والمطلع ص 182، وفتح الباري م/ 103].
والجفن: وعاء السيف، ومنه سمّى: الكرم جفنا تصورا أنه وعاء العنب. [المطلع ص 361، والتوقيف ص 247].
- وقيل للبئر الصغير: جفنة تشبيها بها. [تهذيب الأسماء واللغات 3/ 53، والمغني لابن باطيش 1/ 57، والتوقيف ص 247].
[شرح زروق على الرسالة 1/ 84].
والجلة: البعر، فوضع موضع العذرة، لأن الجلّالة في الأصل التي تأكل العذرة، وتكون الجلّالة من بعير، وبقرة، ودجاجة، وإوزة، وغيرها. [المطلع ص 382، وتحرير التنبيه ص 192، 193].
وقال الفيومي: الجلمد، والجلمود مثل جعفر، وعصفور: الحجر المستدير، وميمه زائدة. [المصباح المنير (جلد) ص 40، ونيل الأوطار 7/ 110].
- وقيل: مصدر، بمعنى: اسم المفعول المجلوب، يقال: (جلب الشيء): جاء به من بلد إلى بلد للتجارة. [المصباح المنير (جلب) ص 40، والتوقيف ص 248، ونيل الأوطار 5/ 167، والمطلع ص 269].
بكسر الجيم: الملاءة التي تلتف بها المرأة فوق الثياب. قال النووي في (تحرير التنبيه): هذا هو الصحيح من معناه، وهو مراد الشافعي، والمصنف، والأصحاب. - وقيل: هو الخمار، والإزار. - قال الخليل: هو ألطف من الإزار، وأوسع من الخمار، وقيل: أقصر من الخمار وأعرض من المقنعة تغطى به المرأة رأسها. - وقيل: ثوب واسع دون الرداء تغطى به ظهرها وصدرها. - قالت الشاعرة جنوب أخت عمرو ذي الكلب ترثيه: - وقيل في حديث أم عطية رضي الله عنها: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها». [البخاري 1/ 88]: أي إزارها، وقد تجلبب. - وقال يصف الشّيب: وفي القرآن الكريم: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: الآية 59]- قال ابن السكيت: قالت ليلى العامرية: (الجلباب): الخمار. - وقيل: (الجلباب): ملاءة المرأة التي تشتمل بها، واحدها: جلباب، والجمع: جلابيب. وفي حديث عن علىّ- كرّم الله وجهه-: (ومن أحبّنا- أهل البيت- فليعد للفقر جلبابا أو تجفافا) [النهاية 1/ 283]. - قال ابن الأعرابي: (الجلباب): هو الإزار، قال: ومعنى قوله: (فليعد للفقر): لفقر الآخرة. - قال أبو عبيد: قال الأزهري: معنى قول ابن الأعرابي: (الجلباب الإزار) لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجلّل جميع الجسد، وكذلك إزار الليل، وهو الثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. [تهذيب الأسماء واللغات 3/ 53، وتحرير التنبيه ص 66، ونيل الأوطار 3/ 287، والنظم المستعذب 1/ 71، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 46، والقاموس القويم 1/ 125].
قال النووي: وهو أكبر من الماش. قال أهل اللغة: وهو الخلن- بضم وتشديد اللام المفتوحة. [القاموس المحيط (جلب) ص 88، وتهذيب الأسماء واللغات ص 55].
[تهذيب الأسماء واللغات 3/ 53، وفتح الباري/ المقدمة ص 104، ونيل الأوطار 3/ 134].
والمرأة الجلحاء: التي انحسر شعر رأسها، والجلحة: موضع انحسار الشعر. قال الفيومي: وأوله النّزع، ثمَّ الجلح، ثمَّ الصلع، ثمَّ الجلة. [المصباح المنير (جلح) ص 40].
الجلد: غشاء جسم الحيوان، وجمعه: جلود، قال الله تعالى: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً} [سورة النحل: الآية 80] وقال الله تعالى: {ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللّهِ} [سورة الزمر: الآية 23]: كناية عن شدة تأثرهم بذكر الله تعالى ظاهرا وباطنا. [معجم المقاييس (جلد) ص 221، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 125].
[معجم المقاييس (جلس) ص 222، ونيل الأوطار 4/ 118، 5/ 310، والتعريفات ص 68]. |